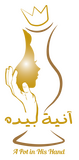بقلم غدير حنّونة
لنبدأ، حيث بدأت الرحلة في أيلول الماضي لسنة 2021، كانت فرصتَها الأخيرةَ لتكونَ أو أن تُكمِلَ حياتها في ما لا تكون، حلمٌ إمتدت صورهُ لعشرينَ عامٍ حينما كانت أمّي معلّمةً ثلاثينيّةً لرياضِ الأطفالِ في إحدى مدارسِ المدينة، حينما نَذرتْ كلَّ قلبِها لتشاهدَ وتساندَ جيلاً تلوَ الآخرِ تصنعُ فيهم غدًا أطيبَ وأصفى كذاكَ القلبِ المنذور، فقد كنتُ أجلسُ على مائدةِ الطّعامِ بعدَ المدرسةِ أستمعُ وإخوتي ليوميّاتها عن كلِّ طفلٍ وعن كلِّ جيل، وكيفَ كانت تتعاملُ معَ كلِّ المواقفِ اللّيِّنةِ منها والصَّعبة، وكيفَ أنّ كلَّ الأطفالِ بكلِّ ألعابهم المتشابهة يختلفونَ في النُّضجِ والتفكيرِ والتطوّر، واختلافَ الطّفلِ المدللِّ عن الذي يفتقرُ الدلالَ أبدًا؛ فالأولُ يحتاجُ لبعضِ الأنظمةِ والحدود، أما الثاني سيكتفي بعناقٍ حقيقيٍّ من ذويهِ بينَ الحينِ والآخر، كنتُ أتركُ صحنيَ ممعِنةَ الإصغاءِ والنظرِ لحكاياها التي غالبًا ما كانت تختمُها بجملةٍ واحدةٍ: “حينما أُنشئُ حضانتي الخاصّة، سأبدِّلُ ما ينقص.” لم نكن نأخذُ موضوعَ تلكَ الحضانةِ على مَحمَلِ الجِدّ، إذ يتوسّدُ التردّدُ عيونَ أمّي في كلِّ مرّةٍ تبوحُ بذاكَ الحُلم، فنتردّدُ نحنُ أيضًا.
لنُكمل، حيثُ تُكمِلُ الأيّامُ مرورَها وتبقى أمّي هي هي في غرفةِ صفّها الأوّل، والحلمُ هو هو في عيونِها، وتمرُّ السّنونُ ونمضي كبارًا برواياتها التي أحاكتها بدقّةٍ، وبدفترها الصغيرِ الذي كانت تسجّل عليهِ أفكارَ مشروعِ حضانتها: “سنضعُ بثًا مباشرًا لأهالي الأطفال، وسنقومُ بإدراجِ علاجٍ طبيٍّ منتظم، ما لا يوجدُ نريدهُ بأن يوجدَ في هذه الحضانة”، كنتُ قد مضيتُ أنا أحاصِرُ واقعًا يُحاصِرني؛ عِراكُ الحياةِ الطبيعيِّ الذي نحاولُ فيهِ تهريبَ أعوامنا بسلامٍ وسلامةٍ حينما كنتُ مُقبِلةً على الاستقرارِ الوظيفيِّ، تصوُّرٌ ورديٌّ لكلِّ متخرِّج، حماسٌ عالٍ لتوقُّعاتٍ بُنيتْ منذُ الصِّغرِ، لكن تعدّدتْ وظائفي وتغيّرتْ كثيرًا وكثيرًا بحثًا عن استقرارِ واحدٍ فقط، كانت طريقًا قاسيةً والظروفُ كانت أقسى، لن أنسى حينما بدأتُ أشعرُ بالاستسلامِ والوِحدةِ، وبأنَّ الحياةَ بمن فيها قد إتّفقوا عليَّ، سوايَ دونَ مَن حولي ممّن استقرّوا في دراساتهِم وعملهِم.
“لا بدَّ للّيلِ أن ينجَلي” هي حقيقةٌ، عندما استيقظتُ على رسالةِ قبولي لعملٍ لم أصدِّق بأنّه تحقّق! هو ما تخيّلته منذ صغري، بل وفي مكانٍ أجملَ بكثيرٍ ممّا تخيّلت، بالقُربِ من بابِ العامودِ في القدسِ، قُدسنا، عملٌ أحبّهُ كثيرًا وراتبٌ ممتازٌ رغمَ صعوبةِ المعابِر ولكن لا بأس، فقد وجدتُ ما سعيت، كنتُ – وأخيرًا – سعيدةً مستقرّةً، “سأصمدُ هذهِ المرةَ” قلتُ لنفسي وصمَدْت، صرتُ أستيقظُ على مَهَلٍ، أجهِّزُ فَطوريَ وأغازلُ الهواءَ لو أردتُ فلا شيءَ يعكِّرُ صَفوَ حياتي الآن، أقرأُ بعض الكتبِ في الحافلةِ أو أكتبُ قصصَ الناسِ الجالسينَ فيها، منهم المشتّتُ ومنهم السّعيد، ومنهم من أنهكهُ التّعبُ تعبًا آخرَ وما زال يحلُمُ بابتسامةِ ابنتهِ حينما يعود للمنزلِ حامِلاً لها جيثارةً كانت رثّةً على حافةِ الطريقِ حيث يعمَل، كان وضعَها في كيسٍ أزرق، صلّيتُ لابنتهِ بأن تبتسمَ لتحقيقِ حُلمِه، فامتعاضها سيكونُ – بالتّأكيدِ – نهايةَ أحلامِ أبيها. هي صورةٌ لا يستطيعُ المرءُ تخيّلها، فمن يستطيعُ رؤيةَ الخيبةِ في عيونِ أهلهِ لا بل ويكونُ هو سببُها.
مُكمِلينَ في الأيّامِ حيثُ لم تشأ لنا الأيّامُ بأن نُكمِل، حينما اجتاحنا فايروس كورونا مُغلِقًا كلُّ شيء، أغلقَ العالمُ بابَهُ ونامَ طويلاً طويلاً، أُطفِأت جميعُ المساعي والأحلامُ رحلت لترتاح، تستطيعُ سماعَ الهدوءَ في اليومِ الثاني من الإغلاق، هدوءٌ عالٍ مزعجٍ ذي طابعٍ مرهِق، خسِرَ العالمُ العالمَ، وأضحى بلا شيءٍ في غضونِ ساعات؛ أصبحَ بلا معرفةٍ وبلا يقينٍ لما كانَ يعرف، دونَ أيَّ سابِقِ إنذارٍ يبتاعُ منه قوتًا ليطمئِن. عامان فقط كانا كافِيان لقذفي من جديدٍ إلى هاويةِ البدايةِ الأولى، وكأنّي عُدتُ دونَ عمري إلى قلقِ الخرّيجِ الجديد، ماذا الآن وبَعدُ…
- أينَ ذاكَ الدفترُ يا أمي؟
- أيَّ دفتر؟
- ما رأيكِ باسم Baby Tune? أم Baby toon?
ابتسمتْ بحجمِ خوفِها، وأجابت بقلقٍ: “أتقصدينَ دفترَ الحضانة؟ أأنتِ على ما يرام؟ الحمدُ لله بأننا نستطيع تعبئةَ البِنزين! أسكتي باللهِ عليكِ.”
- BABY ZONE !!! الله… اسمٌ ذو نغمٍ.
- …
أحضرتُ دفترَها ووضعتهُ يساري وجلست أمّي على اليمين، وفتحتُ الحاسوبَ وبدأتُ أُقلّبُ في صفحاتِهِ لنماذجَ الحضاناتِ المحليّةِ والأوروبيّةِ، وبدأتُ أقترحُ الألوانَ دون وعيٍ عن كيف، وراحت الاقتراحاتُ تزداد ورحنا ندوِّنُ الملاحظاتِ بالتناوب، صنعنا اسمًا وخطّةً ورسمًا هندسيًّا، “غدًا، سنتّصل بالمهندسة!”
- لقد جنَّ جنونُكِ تمامًا.
نعم، كان قد جنَّ جنونيَ انتفاضًا على دوامِ الحالِ الروتينيِّ الخائفِ منَ المخاطرة، هي مرةٌ واحدةٌ، فرصةٌ واحدةٌ، إمّا أن تكون أو لا تكون، كان يجبُ ويجبُ التمرّدَ على أي وضعٍ يعيقُ أيّ هدف.
مرَّ شهرٌ كنّا فيهِ قد دوّنا كل شيء: رأسُ المالِ، المخطّطُ الهندسيّ، البرامج التربويّة والتعليميّة، أسماءُ العمّالِ والمشرفين، المكانُ وساعاتُ الدوامِ، عمر الأطفالِ المسجّلين، مؤهلاتُ الموظفينَ والمعلّمين، البرامج الطبيّةِ والغذائية. لم نكن أبدًا مستعدّينَ ولكنّنا قُلنا آمين، لتمرَّ سنةٌ من أتعبِ السنينَ التي مرّت، لن ننساها، وفي كلمةِ النسيانِ ذاكرةٌ قويّةٌ لا ترحل. أُفتُتِحت الحضانةُ وكانت أصواتُ نبضاتِ القلبِ مسموعةً بالسَّمَعِ المجرّد، هل سننجح؟ كلّ شيءٍ راحَ يلينُ عند ضحكاتِ أوّلِ أطفالنا في الحضانة يومًا بعدَ يوم، أطفالنا الذينَ أعطونا سعيَ مواصلةِ المشروعِ من قبلِ أن نلتقيهم، فقد التقيتهم في قلبِ أمّي الذي لطالما شبّهتهُ بعَلَمِ السّلام، ها هي حضانتنا الآنَ قابعةٌ بلا منازِعٍ بكلِّ ما يميّزها وبأدقِّ التفاصيل وقتما كانت مجرَّدَ أمنية…
أحيانًا كثيرة أُسائِلُ نفسي، أهذا ما سعيتي لأجلهِ اللّيالي تفكّرين في مستقبلكِ؟ أكنتِ تتصوّرينَ نفسكِ هنا حينما كانوا يسألونَكِ في مقابلاتِ العملِ عن أينَ تجدينَ نفسكِ بعدَ خمسِ سنوات؟ في الحقيقة لا، لكن ماذا لو خابَ وجهُ العامِلِ حاملُ الجيثارة؟ فقد كان عليهِ المجازفة لتحقيقِ ابتسامةٍ يغزوا بها العالَم، لا بدَّ والمجازفة، أعلمُ بأنّهُ لم يَكن حُلمي، لكنّها كانت أمّي.