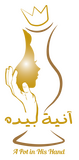بقلم ساندي خوري.
“البنت ما بتطلع من بيت أهلها إلا لبيت زوجها، ومن بيت زوجها للقبر” كم مرةٍ سمعتِ هذه العبارة تتردد أصدائها في آذانكِ؟
خلال السنوات الستة الأخيرة، خاصة بعد تخرجي من المدرسة، قررت أن أنتقل للعيش ببيت جدتي في القدس القديمة لكي أتمكن من العمل في مجتمعي لأن أهلي كانوا يسكنون في دير منعزل في بيت شيميش.
عشت عند جدتي ما يقارب الأربع سنوات, بعدها وبسبب عملي لساعات متأخرة من الليل ودراستي أصبحت أتنقل ما بين البيوت، يوم في بيت جدتي، يوم في بيت عمتي، يوم آخر في بيت خالي، وأحياناً كثيرة في بيت صديقتي، وفقط نهاية الاسبوع كنت أقضيه في بيت أهلي بالرملة. في هذه الفترة اختبرت حياة عدم الاستقرار والراحة، كنت مرهقة نفسياً وجسدياً, كانت سيارتي هي خزانتي وبيتي ومكتبي، كانت مكان استقراري الوحيد.
قبل فترة ليست بعيدة أخذت فكرة الاستقرار في بيت خاص لي تشغل فكري، كنت أعلم أنني سأقابل طريق مسدود ومعارضة شديدة من قبل العديد من الأشخاص على رأسهم أهلي. وفعلاً قابلت ما كنت اتوقعه، معارضة شديدة ورفض قاطع، جعلتني أنسى الموضوع لفترة قصيرة, ولكن سرعان ما عدت للتفكير الجدي في البحث عن بيت آمن أستطيع أن أسكن فيه.
بدأت مشروع البحث عن منزل دون موافقة تامة من أهلي، ولكن كنت أعلم أنهم سيتفهمون الموقف حين اقوم بمناقشته معهم، وعندما وجدت البيت المناسب لي قررت طرح الفكرة مجدداً امامهم.
الجملة الاولى التي قابلتني بها امي كانت: “البنت ما بتطلع من بيت اهلها الا لبيت زوجها، ومن بيت زوجها للقبر”.
عندما سألتهم عن معنى كلامهم، تمحورت أجوبتهم بأننا نعيش في مجتمع شرقي لا يرحم الفتاة، “حتى مريم العذراء تكلموا عليها بالسوء، في بلدنا لا يوجد فتاة تعيش لوحدها، الا إذا كانت قد ارتكبت شيئا جعلها تهرب من بيت اهلها، ولا اجد مبررا آخر يدعوها لذلك” أضاف والدي.
لذا رفضوا أن يضعوا انفسهم وابنتهم في تحدي مثل هذا, لكنني لم أقبل رفضهم للموضوع فتحدثت الى جدتي التي كانت معي كل فترة معاناتي بالتنقل من بيت الى آخر، كانت متفهمة جداً ومتفقة معي تماماً في قراري هذا واستطاعت ان تؤثر على قرار اهلي بالقبول.
تربطني بوالدي علاقة مميزة جداً، فهو يريدني ان اكون تحت سقفه حتى بعد زواجي، ولكن مكان سكنهم كان بعيد جداً عن مكان دراستي وعملي، فكنت محتاجة الى مكان يضمني، مكان يكون خاص بي، مساحتي الخاصة، لم اكن افكر قطعياً انني اريد الخروج عن طوع ابي وعائلتي، لأننا عائلة مترابطة جداً, لكنني كنت أبحث عن الاستقرار الذي كان ينقصني خلال السنوات الستة الاخيرة، كنت أبحث عن نفسي، خصوصيتي، واستقلاليتي.
اردت ان اوفر لنفسي الجو الطبيعي من الراحة والهدوء الذي لم أحظى به معظم الوقت، اردت ان اجد الوقت والمكان المناسب حتى اقضي وقت مع نفسي، اردت ان اختبر امكانياتي واطور مهاراتي، واردت بشدة ان اعتمد على ذاتي في كل ما افعل، من دخولي وخروجي، نومي واستيقاظي، اكلي وشربي، كسلي ونشاطي.
كثير من الفتيات يغادرن منزل الأهل وأحياناً الوطن نفسه بحثاً عن الاستقلالية والعمل وتكوين الذات، فتكون صدمتهن مع الواقع والمجتمع الذي يملك نظرته الخاصة تجاه الفتيات المستقلات، وهي في الغالب نظرة مليئة بالاتهامات، فيعتقد البعض أن الفتاة المستقلة فريسة سهلة، وهذا يضعها في موقف الدفاع المستمر عن نفسها تجاه هذه الاحكام، ونظرة المجتمع الخاطئة إليها, وعلى الرغم من هذه النظرة المشككة بالفتيات المستقلات، إلا أنه من خبرتي الشخصية يمكنني القول بأن الحياة المستقلة تمدني بالثقة بالنفس وتعزز قدراتي وقوتي في مواجهة صعاب الحياة, هذه الحياة والاستقلالية خلقت مني فتاة قادرة على خوض الحياة دون مساندة أحد.
إن الاستقلالية سيف ذو حدّين, هناك الكثير من المنافع التي تأخذها الفتاة من حياتها المستقلة، مقابل الكثير من التحديات والصعاب، نظرة الناس والمجتمع لا ترحم، والفتاة البعيدة عن أهلها تظل دائما محلّ شك حتى تثبت العكس. السؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا لا يمكن للفتاة العيش وحدها؟
إجابتي هي، ليس لعدم وثوق الاهل بالفتاة، بل لأن المجتمع الشرقي يركز على القيم الأسرية، لذلك تُمنع الفتاة من الاستقلال عن أهلها إلا عند زواجها. عمل المرأة بشكل عام منحها هامشاً مهماً من الحرية والاستقلالية، ولكن في المقابل عرّضها للكثير من المشكلات التي لها اثر سلبي على حياتها, لأن عيش الفتاة بمفردها يحتم عليها مواجهة نظرة سلبية من قبل المجتمع الذي يستضعف المرأة ولا يحبذ استقلاليتها.
تبقى حالتي من الحالات النادرة للفتيات الفلسطينيات اللواتي حاولن الخروج عن المألوف، في ظل مجتمع لا زال يحرم المرأة من أبسط الحقوق بالتعليم، والميراث، واختيار شريك الحياة .