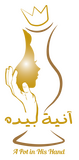بقلم رزان ناظم بنورة
سألني شخصٌ ايطاليٌ: في سؤالٍ عابرٍ بالنسبة إليه، وليس بعابرٍ بالنسبة لي عن إسمي، إسمي الذي لم أتخطى وقعه لسنوات طويلة من سنوات عمري !
أجبتهُ دون اهتمام: ” آية، اسمي، آية “
فسألني بالايطالية: ما معنى اسمك يا آية؟
نظرت إليه مبتسمة ابتسامة مبهمة متسائلة بعيوني عن سبب أسئلته ..
فضحك، مستفسراً عن سبب ابتسامتي مقلداً للتسائل الذي ظهر على عيوني برفع احدى حاجبيه إلى الأعلى.
وقبل أن أجيب, عاد وسألني: ” قولي لي أيضاً سبب تسميتك بهذا الاسم ؟ ” , وظل يُحاول أن يتقن إفهامي بلغته الإيطالية الفقيرة عندي, بإعادتهِ لنفس السؤال بصيغ أخرى في إنٍ واحد:” اي لماذا أطلقوا عليك هذا الاسم, ممم أي المناسبة التي سموكِ لأجلها, أي سبب التسمية “, وظل يكرر محاولة افهامي بأسئلتهِ المتكررة ظناً منهُ أنني لم أفهم سؤاله نتيجة صمتي, لكنني لم أخبرهُ بأن صمتي كان الإجابة الوحيدة التي أملكها, فإنتهت استجواباتهِ عندما أصابهُ اليأس جراء محاولات إفهامي, وشرع بإخباري بعدها عن إسمهِ والمناسبة التي جعلتهِ يحظى بهذا الإسم, وأنا تابعت الاستماع, فقط.
لم تجمعني صدفةً بهِ بعد أن غادر فلسطين, لكنني تابعتُ تذكر أسئلته طويلاً طويلاً ..
” أنا آية, أية عرفات ..
عرفات هو اسم عائلة (الرئيس الراحل ياسر عرفات), وهو اسم عائلتي أيضاً, ليس لأنه أبي أو عمي أو أحد أفراد أسرتي الصغيرة, أو أحد أفراد عائلتي الكبيرة.
عرفات هو اسم المؤسسة التي نشأتُ بها, والتي سُميتْ كذلك نسبةً إليه؛ لأنه إفتتحها لتضم الأطفال الذين لا أهل لهم, ليمنحهم اسمه الكبير, وعطفهِ الأكبر, وسنين لا تُنسى في ربيعهم الأول بداخل جدران هذه المؤسسة.
ومن حسن حظي أو تعاسته, لا أدري .. كنتُ أنا آية عرفات, إحدى الناشئات في المؤسسة العرفاتية الكبيرة.
وبحسب ما أخبرتني بهِ مربيتي سميرة, أطلق البّواب عليّ إسمي ” آية”, وعندما سألوهُ لماذا آية ؟
أجابهم:” لأن الآيات موجودة بالقرآن والإنجيل, ونحنُ نجهلُ أصلها الديني, لكننا لا نجهلُ أصل الآيات”.
أنا لم ألتقي بالبواب مصطفى؛ لأنهُ توفيَّ بعد سنة من تاريخ قدومي إلى المؤسسة, أو تاريخ إحضاري فعلياً, لكنني أُحبهُ لأنهُ أعطى إسمي جوهراً, وقصة ليست كقصص الأسماء الباقية, بغض النظر إن أحببتُ إسمي أم لم أحبهُ يوماً.
فليرحمهُ الله, هو ومربيتي سميرة أيضاً.. فلقد كانت سميرة بالنسبة لي, كل ما أعرفهُ عن معنى لفظ ” أم” وإن كانت تلك المعاني تختلف باختلاف الأمهات.
لم تكن حياتي طبيعية كحياة أي فتاة طبيعية, مممم
أظنني سأغير الجملة وأبقيها في آنٍ واحدة, سأُعيد صياغتها, وأُكمل…:
لم تكن حياتي طبيعية كحياة باقي الفتيات, فالطبيعي هو أن تحظى الفتاة بوالد ووالدة أو حتى أقارب إذا ما توفى أحد الوالدين أو كلاهما, وفي حين كانت تحظى الفتيات بحياة طبيعية, كنتُ أنا أحظى بحياة عادية طبيعية نسبياً, فأنا ما كنتُ سأعرف يوماً بأن حياتي ليست طبيعية لولا وجود زميلاتي في المدرسة التي لم أحظى بصديقة منهن أبداً .
لقد تابعن باستمرار بُغضي, وتابعتُ أنا بكائي وصمتي وعُزلتي والشكوة لوالدتي سميرة.
لقد كانوا يقُلن لجميع زميلاتي بأنني إبنة المؤسسة, ويبتعدن عني, ويطلقن المسميات علي, ويغيرن كلمات الأغاني المشهورة, ويغننها لي. لقد كنتُ لعبتهن التي يتسلين فيها دوماً, وما أن أتت طالبة جديدة لصفنا, حتى كنتُ أُفكرُ في جعلها صديقتي, لكنهن كانن يكسبنها لصفهن قبل أن يصدر من تفكيري أي فعل إجتذاب, وجيدٌ أن هذا لم يحدث, فما كانت أي واحدة من الطالبات الجدد ستفرح بأن تكون صديقة لي وتكسب عداوة الجميع !
ما كنتُ سأعرف أبداً أن حياتي ليست طبيعية لو أن محيطي لم يوّجب على الإحساس بذلك .
انتهت سنوات تعليمي الثانوي, ولم أكن أُريد أن أحظى بتعليمٍ جامعيّ أتابعُ كسب أعداءٍ جدد فيه, من غير قصدٍ مني.
لكنني حظيتُ بتعليمٍ جامعيّ من غير رغبةٍ مني, والصورة التي رافقتني في مدرستي تابعت مرافقتي، لكن بصور متزايدة مُتداخلة ظننتُ بأنني لن أنتهي منها يوماً.
تغيرت حياتي كلياً في الجامعة, وأول تغير كان عليّ أن اجتازه، هو عدم وجود والدتي سميرة لأشتكي لها.
ولقد كان أمراً صعباً عانيتُ منهُ بشدة, مع أنها كانت لا تفعل شيئاً سوى الاستماع إلي ومحاولة إرضائي وتصبيري, إلا أنني إكتشفتُ بعد رحيلها أن هذا كُل ما كنتُ بحاجة إليه !
” ستكونين آية يا آية, أرى ذلك في تقسيمات وجهكِ” كانت تقول لي هذه الجملة وتذكرني بها كلما إشتد حُزني.
لكنني لم أكن (سندريلا) بجمالي, لكي يعوضني عن حُزنٍ ولدتُ أتنفسهُ وأحياهُ رغماً عني, كما أنني لم أحظى بحب أمير وأنا من العائلة الحاكمة –افتراضاً- ليرى بداخلي أكثر من ملامحي الخارجية !
أنهيتُ دراستي الجامعية في خمسة سنوات كان من المفروض لها أن تكون أربعة, وسنتي الأخيرة في الجامعة هي التي كانت نقطة الفصل والوصل في حياتي الفقيرة من كل شيء سوى المال؛ فلقد حظيت بتبرعاتٍ كثيرة من المال طوال سنين حياتي ما قبل إنهاء الجامعة؛ لأنها الطريقة الوحيدة في نظر المتبرعين التي ستعوضني عن فقدي لكل شيء سواه.
بعد عُزلتي التي دامت سنوات طويلة, إستطعتُ بصدفة قاتلة أن أنضم لاجتماعٍ عابرٍ, ومن هذا الاجتماع لمؤسسة تبعتهُ, اخترتُ الانضمام إليها بنفسي دون أن يُحضرني إليها أحد كما مؤسسة نشأتي.
بطواعية غير مسبوقة مني, بدأتُ أأخذُ منحنياتٍ أخرى لنفسي ولحياتي عندما كسرتُ صمتي بكلامٍ قَطَعَهُ بكائي في إحدى جلسات المؤسسة حين واجهتُ تَهجمْ أحدهم على الفتيات من مؤسستي بوصفهن بالساقطات, ومواجهتي حينها لم تتعدى الكلام والبكاء وكأنهُ الدفاع الوحيد الذي كنتُ أملكهُ” أن أحكي وأبكي ذاتي”.
بعد أن إعتاد الجميع صمتي, إستطعتُ أخيراً أن أتكلم, بعد أن قضيتُ أعواماً كثيراً أبكي بعزلة, بكيتُ حينها بحرقة كبيرة أمام الكثير من الأعين التي شاركتني بكائي, وكثيرٌ من الأذن التي سمعتني بإصغاء,
وكأن نقطة التحول بدأت حينها, بأن أشكو حُزني, وأُحارب صمتي الذي عذبني أكثر من مُجريات الأحداث.
عدم قدرتي على المواجهة أو حتى الدفاع عن نفسي هي التي أسكتتني مطولاً, لقد تكلمتُ أخيراً, وبعدها لم أصمت أبداً !
لم أتكلم صراخاً أو معاتبةً, ولم أكره الناس ..
استطعتُ أن أتقبل نفسي ليتقبلني من حولي, استطعت أن أحب نفسي, وأن أحظى بحبٍ لم أكن أتوقع الحصول عليه يوماً.
احترمت جميع من حولي, والذين يبغضونني أولهم, فازداد احترامي لنفسي بطريقةٍ غامضة معينة.
كل هذا حصل في سنتي الخامسة الأخيرة في الجامعة, التي من الوضع الطبيعي أن لا أخوضها ،فمن الطبيعي أن أنهي دراستي في أربعة أعوام.
لكنني منها اكتشفت أن هناك الكثير من الأمور التي تخرج عن وضعها الطبيعي, لكن بخروجها هذا عن مسارها الطبيعي, تخلق مسارات جديدة تكون ما نحن فعلاً بحاجة إليه لخوض بداية لطالما انتظرنا خوضها.
قبل انضمامي لذلك الاجتماع في سنتي الخامسة, كنتُ في هاوية النهاية لحياتي, حينها حاولت قتل روحي بأن أفكر بالانتحار؛ بأن أقتل نفسي وأقتل معي محتلاً أو اثنين, أو مجموعة منهم, بحسب الوضع الذي كان سيكون الأمر عليه.. كنتُ أُفكر بماذا سيتحدثون بعدي, فسيكون أقلُ هوناً علي بأن يقولوا ماتت شهيدة بدلاً من أن يقولوا ماتت حزناً لأنها —.
أما اليوم, وها أنا على مشارف نصف الثلاثينيات من عمري.. لقد تعديتُ مرحلة التفكير, وإنتقلتُ إلى مرحلة التطبيق ..أنا اليوم رئيسة لجمعية رعاية الطفل, وكذلك عضو اللجنة التأسيسية لمؤسسة التربية والعائلة للأيتام, كما أنني أحرص بشكل شخصي حرصاً شديداً وعناية كبيرة بأن أجعل كل طفل يعيش حياة طبيعية إنسانية وأن يحظى بجميع الفرص التي يحظى بها أي إنسان طفل في أي مكان من العالم, وبأن يشعر باستمرار بإمتنان لله ويشكرهُ لأنه أعطانا هذه الروح لتحيّا على هذهِ الأرض, ويستغل وجود جسدهُ على الأرض, ليحظى بحياة أبدية في السماء؛ بأن يحقق الإنسانية بسلوكهِ وأعمالهِ وينسى أمر كل من يحمل لهالعداء.
أنا اليوم أشعرُ بامتنان كبير, لكل فشلي وكل حزني وكل الأيام السيئة التي عشتها, لأن كل هذا جعلني أصل إلى ما أنا عليه اليوم.
أنا اليوم تحديداً في شهري ما قبل الأخير لإنجب طفلتي “شغف” , وقد حظيتُ بحبِ رجلٍ أظنهُ الأقدس؛ فقد رأى ملامحي الحقيقية دون أن أُحاول إظهارها, وقد نظفَّ الغُبار عن كنزي, فجعلني أرى اللمعان الحقيقي لنفسي الداخلية.
وكما أنا الآن ,, سأتابع تحقيق طموحاتي وأقاتلُ بحب لكي أحقق ذاتي وأحمي أسرتي, وأُبعد عنها النقص قدر الإمكان, وإذا ما عاندني طريقي, فلن يعاندني القدر, سأتابعُ الوقوف بعد كل فشل, وسأتابع الحبُ مهما كَثُرَ من حولي البغض, سأكون أنا باستمرار, وإن” أنا” تغيرت, سأطيعها”.
هذهِ رسالتي لذلك الإيطاليّ الذي لم تجمعني بهِ صدفةً أخرى لأبرر لهُ صمتي حينها, وبما أنني تكلمت, كان لا بد لي أن أُجيبهُ ولو برسالة وإن كانت لن تصل, فيكفي إنني أجبتهُ أخيراً, ليتعدى كلامي إلى ما قبل مرحلة الصمت.
لكن رسالتي لم تنتهِ هكذا, لقد كتبتُ في نهاياتها جملتين:
” معنى إسمي في مجتمعي: ” لقيطة”.
ومعنى إسمي في قاموسي وقاموس اللغة: ” المعجزة، العلامة الخارقة للإنسان، الرسالة، العِبْرة” “.
*ملاحظة: هذهِ ليست قصة شخصية, ولا تتحدث عن شخصية معينة, وأسماء المؤسسات والشخصيات وردت على سبيل المثال لغايات السرد.